News and Opinion:
الإعلام و تصنيع الرأي
Sunday, May 3rd, 2015
بقلم مازن صالحي
المشهد الأول: مسلحون ينتمون إلى فصيل إسلامي يقاتل الدولة السورية يدخلون إلى بلدة قرية في سوريا بعد كسر حاميتها الموالية للدولة. مسؤول إعلامي من الجبهة “الفاتحة” يحمل ميكروفون و تتبعه كاميرا المراسل الميداني، يستوقف بعض المواطنين ليسألهم عن رأيهم في حدث “التحرير”. الأسئلة تُلقى بالفُصحى المنمقة. الإجابات تثني على الفتح الذي أنجز للتو و كلها تثني على حسن أخلاق المجاهدين، و تشكرهم على تخليصهم من ظلم النظام و بطشه. الكل يركز على أولوية الحكم بما أنزل الله، و على تطبيق الشريعة في المجتمع.
المشهد الثاني: بعد المشهد الأول بشهر، الجيش السوري يدخل إلى نفس القرية بعد هجوم عنيف ينجح في كسر دفاعات الفصيل الذي كان يسيطر عليها. نفس الشباب و الأطفال و النساء على جانبي الطريق يلوحون بأيديهم للجنود الذين يمرون محمّلين على ناقلات الجند. مذيعة من التلفزيون الرسمي تحمل ميكروفون و تتبعها كاميرا تلفزيونية، و تستوقف بعض المواطنين لتسألهم عن رأيهم في عودة الأمن و الأمان إلى القرية بعد دخول الجيش إليها. الكل يركز على أهمية التسامح، و على أننا أبناء بلد واحد، و أن جيشنا هو عزتنا.
المشهدان يعطيانا صورة متناقضة، بالرغم من أن المواطنين الذين يتكلمون هم أنفسهم، فأي المشهدين هو الأقرب للحقيقة؟ أيهما هو الأقرب لتوصيف واقع مشاعر أهل تلك القرية؟ هل سبب التناقض الخوف و النفاق؟ أم أن هناك ما هو أبعد من ذلك؟ بل هل هناك فعلاً واقع قائماً بذاته، مستقلاً عن الجهة التي تُراقبه؟ هل هناك “حقيقة” مستقلة عن الاختبار؟
تجهد كل وسائل الإعلام لتقديم نفسها على أن دورها يقتصر في نقل “الواقع كما هو” و أن مهمتها هي في مساعدتك أنت المتلقي على “أن تعرف أكثر” و أن تسمع “الرأي و الرأي الآخر”. نعلم بالطبع بأن كل وسائل الإعلام منحازة، ، و نعلم أنها انتقائية في المادة التي تقدمها بحيث أنها تختار المادة المؤيدة لخطها، و تهمل المادة المضادة. لكن هل يقتصر تأثير وسيلة الإعلام على الانتقائية؟ هل يقتصر تأثيرها في أنها تختار ما ستسلط عليه الضوء و تختار ما ستتركه في العتم؟ هل يمكن لنا أن نتخيل أنها قد تتجاوز النقل إلى أنها قد تغير الواقع بحضورها؟ هل هي، ربّما، تؤثر على الواقع بمجرد محاولتها قياسه؟ بمجرد “تسليطها الضوء عليه؟”
فليسمح القاريء الكريم بأخذ تفريعة عن السياق السابق، لأقيم مقارنة أو استعارة من موضوع علمي متعلق بالفيزياء، حيث نقيم مقارنة مع مشاهدات و تجارب ميكانيكا الكم (Quantum Mechanics) المدهشة، و ذات البعد الفلسفي العميق، خاصة ما يعرف بتفسير كوبنهاجن لميكانيكا الكم. أستسمح العذر ممن لم يكن له معرفة بهذا الموضوع العلمي، لكن إن صبرتم معي قليلاً، فسترون وجه الشبه، و سنتحدث عن سبب إيرادنا للمقارنة. الموضوع هنا هو محاولة قياس “الحقيقة” بأدوات هي من نفس ثقل العناصر المراد قياسها. من أهم النتائج الفلسفية المتأتية عن تفسير كوبنهاجن، هي أنك لا تستطيع أن تقيس حالة جزيء ذري دون أن تؤثر على حالته بمجرد محاولتك قياسه. إن محاولة القياس ذاتها لا بد لها من إطلاق فوتونات (ضوء) باتجاه الجزيئات. لكن بسبب الحجم و الكتلة الصغيرين جداً لهذه الجزيئات، فإن فوتونات الضوء تطرقها و قد تبعثرها و تغير فيها، لا مناص عن ذلك. فتجربة المراقبة لا يمكن إجرائها بمعزل عن أن تؤثر التجربة نفسها، على الجسم المراد مراقبته. شيء مشابه (نتائجياً و ليس فيزيائياً) يحدث عند محاولة كاميرا تلفزيونية التحدث مع مواطن. إن الكاميرا (و بالطبع السلطة التي تمثلها، و معرفة الشخص بأنه مراقب على الملأ) تغير حتماً في تموضع المتلقي و تغير في استجابته، و لا يمكنها قياس “حقيقته” دون التأثير عليها.
في التفسيرات التي يوردها تفسير كوبنهاجن، فقد عُرِّف ما يسمّى بمبدأ التراكب (quantum superposition) لتوصيف الظواهر التي تحتمل أكثر من احتمال، و لكن يستحيل معرفتها دون قياس، مثل تجربة قطة شرودنجر الشهيرة. في هذه الظواهر، تكون حالة (state) الموضوع قيد البحث مبهمة و تحتمل أكثر من احتمال فتوصف (قبل قياسها) بأنها في حالة تراكب، أي هي تحتمل الحالة و الحالة المعاكسة معاً و في نفس الوقت، و قد لا نعرف عنها سوى نسبة الاحتمال. و لكن ما أن يتم إجراء القياس، فإن هذا التراكب ينهدم، و تنهار غيمة الاحتمالات إلى حالة واحدة لا غير.
شيء مشابه يحدث على المستوى البشري، و لعله يفسر تناقض المشهدين الذين قدمناهما أول المقال، و هو أن كل مواطن يعيش حالة من التراكب المضطرب بالنسبة للمراقب الخارجي فهو “مؤيد” و “معارض” في نفس الوقت، و هو مع الفصيل (آ) و مع الفصيل (ب) المعادي له في آنٍ معاً لكن باحتمالات مختلفة. إلا أن هذا التراكب يمكن أن يظل خفيّاً حبيس الصدور، ما لم يتعرض للاختبار. و بمجرد طرق الفرد بالاختبار، فإن حالة التراكب هذه تنهار، لتخرج منها حالة واحدة، هي في الغالب الأعم مطابقة لما تريده الكاميرا: إما مؤيد، أو معارض؛ إما (آ) أو (ب). فنحن إذن أمام ظاهرة على المستوى البشري الاجتماعي، نواجه فيها جهلنا المبدأي لما يدور في أخلاد الأفراد، كما تواجه ميكانيكا الكموم الجهل المبدأي بما يحدث على المستوى الذري. يلخص التشابه في نقطتين هما أنك أولاً لا يمكنك قياس الواقع دون التأثير عليه، و ثانياً أن عملية القياس تهدم حالة التراكب (عدم التحديد) لدى المتلقي، و تجبره على اختيار اتجاه.
هذه النتائج يجب أن تخيفنا، لأنها تعني أنه لا وجود حقيقة للرأي بشكل مجرد، لأن في كل منا كل التناقضات التي تجعله يحمل الشيء و نقيضه، حتى يأتي الاختبار، بالكاميرا أو بغيرها، الذي يجبرنا على اتباع حالة معينة. هذه النتائج كذلك تعني أن الرؤى و الآراء و التصورات السائدة لدى مكونات المجتمع تجاه قضية ما، كلها توابع، قسراً، للإعلام. الإعلام، بمجرد حضوره، يصنّع رؤية الناس و تصوراتهم، و ليس فقط يراقبها أو ينقلها، بل هو فعلاً يصنّعها، خاصة عندما يسبق إليها، و يباغت المتلقي الذي لم يخرج بعد من حالة التراكب أو عدم التحديد. تسليط الضؤء الإعلامي على موضوعٍ ما، خاصةً إذا جرى في وقت مُبكر، يغير طبيعة هذا الموضوع لدى المتلقي الفرد و المجموع، في الاتجاه الذي تريده الجهة الممسكة بالكاميرا. هذه نتيجة خطيرة.
قد يقول قائل أن الظاهرة التي نرقبها ما هي إلا تجلٍ للرغبة بالنجاة (survivalism) و لكن هذا غير صحيح، فهناك مشاهدات لهذه الظاهرة حتى في حالات لا يكون فيها أي تهديد على الإطلاق للمواطن الذي يوضع أمام الكاميرا. تابع مثلاً هذه المقابلات مع أفراد في الشارع يتفاعلون مع خبر لا يصمد أمام أدنى تفكير نقدي أو منطق، مثل هروب الديناصور من حديقة الحيوانات [1]. شاهدوا كيف يتماشى المتلقون مع طرح مقدمة البرنامج و يتفاعلون معه على أنّه مُعطىً منتهي. هذا ليس تمثيلاً، و لا ينطبق فقط على شعب معين أو ثقافة معينة (هناك المئات من الفيديوهات المشابهة في كل دول العالم) بل إن هناك ظاهرة نفسية معقدة هي التي تفعل فعلها هنا، و تضيء عليها مثل هذه التجارب.
لتحقيق التأثير (Influence) على شريحة أو مجتمع معيّن، يبحث الخبراء عن الأدوات التي تمكنهم من التأثير على المجتمع و تغيير آرائه في الاتجاهات التي يريدون. يُستخدم هذا بكل تأكيد في التسويق للسلع، كما يُستخدم، دون أدنى شك، للتأثير السياسي. ضع الأفراد أمام ضخ الإعلام، و ادفعهم في الاتجاه الذي ترغب به باستخدام عدد من الآليات، و سترى الحياد ينهار بسرعة و يبدأ الجذب ناحية ما تريد. هذا مثبت و مؤكد الفعالية. و بعد الانتزاع الأولي من الحياد الظاهري، و بعد أن يدلي الإنسان برأيه على الملأ، و ما لم يتدخل الإعلام المضاد بسرعة و فعالية لعكس الاستقطاب الناشيء، فإن آليات نفسية عديدة تتفعّل أهمها مبدأ الاتساق (Consistency) فتدفع هذا الشخص للتمسك بالرأي الذي أدلى به على العلن. أي أنّه بعد أن أدلى برأي في اتجاه معيّن، سيحاول جهده ألا يكون متناقضاً مع نفسه في المرات التالية، و سيستمر بالتصعيد للحفاظ على اتساقه مع نفسه. موضوع الاتساق و مدى ضغطه الكبير على آلية صنع قرار الفرد هو موضوع كبير جداً و يحتاج لبحث بمفرده.
ماذا يعني كل ذلك؟ إنه يعني باختصار أن السبق في الحضور الإعلامي و اعتماد سياسة الضخ الإغراقي، يعطيان على الأرض فوائد هائلة لمستخدميه، و مردوداً يفوق التكلفة كثيراً، و يعني أيضاً أن إهمال المجال الإعلامي له تكلفة باهظة جداً جداً. أثر الإعلام أكبر بكثير مما كنا نتخيل، و ما التوصيف السابق إلا نقطة في بحر أهمية الإعلام.
لقد دأبت السياسة الإعلامية السورية الرسمية على اعتماد مبدأ “يحكوا ليشبعوا” في مقاربتها للإعلام المعادي، و تركت، لسنوات طويلة، هي سنوات الحياد النسبي لدى الجمهور، تركت هذه الجبهة خاوية تصفُر. بينما عمل الإعلام المعادي بدأب على الاستيلاء على آراء الكثير الكثير من الناس بآليتي السبق و الضخ الإغراقي. و لطالما اتكل المسؤول السوري على قناعات متحجرة لتبرير التقصير الكارثي في الفضاء الإعلامي، كان منها (1) أن كل هذه الثرثرة لا طائل منها، و أن لدى سوريا جيش قوي يمكن أن يردع كل من تسول له نفسه بتحدي الدولة، و (2) أن أي مبلغ يصرف على الإعلام هو بمثابة هدر للمال على الثرثرة، بمعنى أن و كل دولار يصرف على الإعلام هو بمثابة هدر لدولار كان يمكن شراء رصاصة به، و (3) أننا ليس بمقدورنا مجاراة البذخ المالي الذي تصرفه دول الخليج على الإعلام، و لذلك فمن الأفضل لنا ألا نحاول، و أن نركز جهودنا في الميادين التي نفهم فيها (الجيش و السلاح).
لقد كانت تلك القناعات البائسة المتحجرة، و لا تزال، خطأً استراتيجياً كارثي الفداحة. تشير التقديرات إلى أن كلفة إعادة الاعمار في سوريا قد تتخطى المئتي مليار دولار أو ربما الثلائمئة مليار دولار. أنا على يقين كامل، أننا لو كنا رصدنا للإعلام ميزانية سنوية تبلغ واحداً في الألف من هذه التكلفة التي سيتوجب علينا و على الأجيال القادمة دفعها لإعادة الاعمار، لكانت هذه العاصفة التي تضرب سوريا حالياً أضعف أثراً بكثير جداً، مما هي عليه الآن. إن تغيير الآراء و التصورات هو ما دفع بعشرات الآلاف من “المغرر بهم” للتموضع في خانة إسقاط النظام بأي ثمن مهما كان فادحاً. و تكفل مبدأ الاتساق، مع حيل تسويقية عديدة باستمرارهم في الإصرار غير المنطقي على الخط الذي اتخذوه، مهما كلف الأمر. و فيما كان المسؤول السوري يقول “يحكوا ليشبعوا” كان هذا “الحكي” يتصاعد لدى بعض الشباب من كونه كلمة، إلى مظاهرة، إلى عنف، إلى سلاح، و من ثم إلى حالة الجنون المنفلت الذي نراه في أعين “الثوار” و نسمعه في عباراتهم. نعم لقد كان بالامكان، و ضمن قدرتنا ألا نترك الساحة خالية أمام الإعلام المعادي ليلتهم أرواح مواطنينا و يأخذهم إلى أماكن لم يكونوا هم أنفسهم ليصدقوا أنهم قد يصلوا إليها. لكن هذه الجبهة أهملت إهمالاً شبه كامل، و لا زال المستوى فيها دون المطلوب بكثير. على جبهة الإعلام، نحن كمن يواجه مدمرة أو حاملة طائرات، بنقيفة.
أيها المسؤول السوري، لقد آن الأوان لأن تغير تفكيرك في هذا الموضوع، و لأن تغير استراتيجية “يحكوا ليشبعوا” و أن تضع الإعلام كأولوية كبيرة. لقد تأخرنا كثيراً، نعم، و لكن لا مناص من تجهيز هذه الجبهة و فتحها. لا يمكننا أن نُسكت قنوات الفتنة و التحريض و الكراهية المنفلتة من كل حدب و صوب، و لكن يمكننا أن نصنّع الترياق الشافي للكثير من الآفات، و أن نوصله لمواطنينا لحمايتهم من هذه السموم الفتاكة. هذا لا يزال، و سيظل ممكناً مهما حصل. فحيل التأثير و التسويق لا تمشي باتجاه واحد بل باتجاهين، و كل خطة توجه ضدنا لها خطة مضادة تبطلها، و كل سم يصب في عقول جمهورنا له ترياق، و كل نار يشعلونها في نفوس شبابنا يمكن إطفاؤها، ليس بالقوة أو بالرصاص، بل بالاعلام الذكي المحترم الذي يعرف كيف يرصد حملات التأثير، و كيف يتعامل مع كل واحدة منها بما تستحق.
1 – https://youtu.be/-x5b337wWO8?t=32
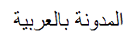


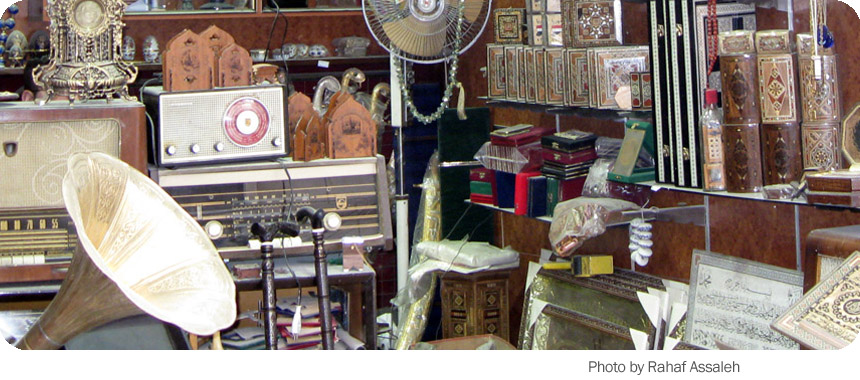



 CreativeSyria
CreativeSyria
Comments (0)
There are no comments for this post so far.
Post a comment