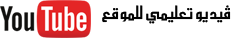منذ بداية الأزمة السورية، خيّم شبح الطائفية الاجتماعية و الطائفية السياسية على المجتمع السوري، و تعالت الأصوات الداعية الى التكتلات الطائفية و العرقية، لأسباب بعضها تاريخية و بعضها الاَخر متعلقة بالتحريض الاعلامي و الديني. شهدت الطائفية دفعة في أعقاب “الربيع العربي”، بعد سقوط الأنظمة القديمة، و أثارة الخلافات الأيديولوجية بين الإسلاميين والعلمانيين، وبين المحافظين والليبراليين، فضلا عن الانقسامات الدينية بين السنة والشيعة والمسلمين والمسيحيين. ومع ذلك، هناك بعد استراتيجي إقليمي لاثارة الفتنة الطائفية بين الشيعة والسنة في منطقة الشرق الأوسط. بطبيعة الحال فتح “الربيع العربي” فرص جديدة للنفوذ الإقليمي، وبالتالي تصاعد حدة التوتر بين ايران ودول الخليج، و تحولت سوريا الى ساحة صراع اقليمي، في شكلها طائفي و لكن بمضمون سياسي استراتيجي بحت.
وقد تحولت الطائفية في سوريا الى مادة للتصنيف السياسي بدلاً من أن تكون مواطنيته هي اساس كل تصنيف، والمؤسف حقاً ان الكثير من المثقفين قد دخلوا او ادخلوا في نفق الطائفية المظلم وأصبحوا يرددون مقولات طائفية تحت الغطاء السياسي، وأصبحت السياسة جزءاً من الحالة الطائفية على طريق تحول الموضوع الثقافي والاجتماعي وحتى الديمقراطي الى مشروع للطائفية، وسيجد هؤلاء المثقفون انفسهم وقد تحولوا الى مدارس للثقافات الطائفية والفنون الطائفية والفلسفة الطائفية. ان كل من هو طائفي بصرف النظر عن نواياه هو في الحقيقة ليس اكثر من جندي في المشروع المعادي لمصالح سوريا العليا في التحرر والديمقراطية والمساهمة الفاعلة بالحضارة الإنسانية، وكل طائفي او مذهبي او شوفيني ليس الا أداة من ادوات الغرب الرأسمالي المتوحش و الخليج القائم على الممالك الدينية الطائفية الذين يضمرون للحضارة السورية و شعبها العداء، ولن تجد اسرائيل حتى لو صنعنا مئات آلاف القنابل النووية من دعم وإسناد اكثر من شرذمة المنطقة وتفتيت شعوبها ونسيجها الوطني والاجتماعي على أسس طائفية او مذهبية[1].
بما أن الطائفية أصحبت أمراً واقعاً في سورية، على الأقل في الوقت الراهن، اذن على مثقفي البلد محاصرتها و محاربتها، و لكن إذا اردنا محاربة الطائفية في المجتمع السوري، علينا أولا اتخاذ موقف من «الطائفية» بشكل عام. أي علينا أولاً الاعتراف بوجود الطائفية في سوريا و وتوحشها خلال الأزمة الراهنة.
1- التعليم هو المفتاح لمحاربة الطائفية والتعصب الديني من النفوس السورية. سوريا بلد متعدد الديانات ومجتمع متعدد الثقافات. السوريون، بغض النظر عن خلفياتهم الدينية و الطائفية، يجب أن يكونوا قادرين على العيش متحررين من الخوف والتعصب والتحيز والتمييز، على أساس من الثقة المتبادلة والاحترام والتفاهم والاندماج و المساواة. و أول خطوة نحو تحقيق هذا الأمر هو تغيير القيم المجتمعية عبر تغيير مناهج التعليم و ادخال قيم العلمانية و الديمقراطية و حقوق الانسان في نفوس السوريين من المدارس الابتدائية. شخصياً لا أعلم ما الحاجة الى دروس الدين في المدرسة. الدين و العبادة هو أمر شخصي بين الانسان و خالقه. لا يجب على أي مدرسة ممارسة التلقين الديني و استبداله بمواد تتعلق بحقوق الانسان و خاصة المرأة و احترام الرأي الاَخر و زرع مبادئ العلمانية، الأمر الذي يسمح الأجيال القادمة على التفكير المبدع بعيداً عن التشوهات الطائفية و القيود الدينية التي تُفرض على أطفالنا منذ الصغر.
2- تعديل الدستور السوري و قانون الأحوال الشخصية: تقول الحكومة السورية أنها دولة علمانية و لكن هذا غير دقيق. الدستور، القوانين و التشريعات السورية لا توحي بذلك. صحيح، أن الحكومة السورية تعطي حرية ممارسة المعتقدات الدينية و الثقافية للحفاظ عليها و ضمان استمراريتها و لكنها لم تساهم الحكومة بشكل فعّال في قطع الطريق أمام نمو الطائفية في سوريا. من المعلوم أن أهم أسباب الطائفية هو الجهل و التربية المنزلية و بعض الجوامع و الكنائس. لذلك، على الحكومة السورية فرض فصل الدين عن الدولة، بكل ما تحمل الكلمة من معنى. فكم من رجل دين ساهم في تأجيج الوضع في منطقة ما، و كم من جاهل صعد الى المنبر و حرّض الناس على الاقتتال الطائفي و الخروج في مظاهرات قالوا عنها “ديمقراطية” و لكن في باطنها طائفية و تعصب مقيت. اذا أردنا المساهمة في الحضارة الانسانية العالمية علينا ان نجاري التطور الفكري و الفلسفي الذي توصل اليه العالم. تخيل أننا في القرن 21 و مازال مرفوض مجتمعياً و دينياً و على مستوى الحكومة التزاوج بين الطوائف و الديانات المختلفة. محاربة الطائفية تتم بتعريف الطوائف على بعضها البعض والحماية القانونية للمتزوجين من طائفة او ديانة مختلفة. نفس الشيء ينطبق على الدستور السوري الذي يمنع المواطن السوري غير المسلم من المشاركة في الانتخابات الرئاسية، و هو بالمناسبة خرق فاضح لمبدأ العلمانية. بالاضافة الى قانون الأحوال الشخصية الذي يعطي لكل مواطن مرجعية دينية او طائفية في حالات الزواج و الطلاق و الوراثة، الخ. يجب أن يكون لسوريا قانون مدني موحّد يضمن تكافؤ الفرص للجميع، بغض النظر عن الديانة او الطائفة او العنصر أو العرق أو الأصل الاجتماعي أو الجنس أو التوجه الجنسي أو الإعاقة.
قد يقول البعض كيف يمكننا أن نطبق هذه الاصلاحات و جزء كبير من الشعب لا يريد او يقاوم هذه القيم الديمقراطية و العلمانية. في البداية الحكومة السورية مسؤولة عن تغيير قناعات الناس و مسؤولة عن الوعي و الادراك الشعبي و هي تتحمّل جزء كبير من المسؤولية. لا أقول أن هذه القناعات يمكن ان يتغير بين يوم و اخر، و لكن يجب أن نبدأ الان لكي لا تتكرر اخطاء الحاضر في المستقبل. في البداية من المفروض تعريف العلمانية تعريفاً صحيحاً. العلمانية ليست احتقار الأديان و ليست الحاد. على العكس تماماً، العلمانية هي احترام كل الأديان و المعتقدات الدينية و لكن حصر هذه الممارسات على الصعيد الشعبي و المجتمعي، و فصلها عن الدولة و السياسة. من سخرية القدر أن الحكومة السورية تمنع الأحزاب الدينية و لكنها لا تفصل الدين عن الدولة. من هذا المنطلق، قد يصبح لأي رجل دين نفوذ سياسي على الشباب و المؤمنين و يمكن تحريك الشارع سلباً او ايجاباً. لذلك، يجب كف يد رجال الدين عن الدولة و السياسة و حصرها في الامور المجتمعية و الدينية.
اعتماد منهج فكري واضح لجميع الطلاب السوريين و في كل المدارس و الجامعات (الحكومية و الخاصة) ألا وهو المنهج العلماني المدني. يجب تعليم الاجيال القادمة حقوق الانسان و احترام المرأة و الرأي الاَخر. يجب تعليمهم اسلوب الحوار بدل القتال. لقد أهملت الحكومات المتعاقبة الريف و لم تتابع تنصّل عدد كبير من أطفال هذه المناطق المهمشة من الدراسة. فكم من طفل لم يرَ جدران المدرسة و خلق عنده/ها الاستعداد النفسي و الذهني لتقبّل أي فكرة مهما كانت بشاعتها و منها الفكر التكفيري؟ و ما الذي يفسّر انتشار هذا الفيروس الخبيث في جسد مجتمعنا و بفترة قياسية؟ قام أعداء سوريا باستغلال هذا الأمر فانتهى المطاف بالكثير من الجرائم بشعة ووصمة عار على جبيننا.
لكل تغيير ثمن، فأتاتورك و ستالين لم ينشئوا نظاماً مليئاً بالورود و لكنهم وضعوا أمّتهم على السكة الصحيحة. الى اليوم لم يستطع أي حاكم تغيير القاعدة الفكرية لهذه الشعوب. اردوغان الفاشي على سبيل المثال، حاول كثيراً و لكنه لم و لن ينجح. الهوية الوطنية هي الأساس، و في سوريا نريد هوية سورية تجمع الكلّ بدون استثناء تحت مظلة وطنية و قانون مدني دون تمييز او تهميش. العلمانية و الدولة المدنية هي الحل. انصاف الحلول و النظام العلماني القاصر قد يبني دولة مستقرة نسبياً و لكن هذه النسبية لا تطول و قد تتكالب عليها الحاقدين و أصحاب المشاريع الصهيونية من العرب و الغرب و أكبر مثال هي الحرب الدائرة في سوريا.
أما بالنسبة للشكل السياسي القادم في مرحلة ما بعد الأزمة، شخصياً أنا مقتنع أن النظام الحالي غير قادر على مجاراة التطورات التي حصلت و تحصل في العالم. النظام الحالي غارق في الفساد و البيروقراطية و المحسوبيات، و هو يُعتبر من أسوأ الأنظمة في الاصلاح السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي بسبب وجود مسؤولين أقل ما يقال عنهم متخلفين عن كل ما يحصل حولنا. و عندما نرفع أصواتنا مطالبين بالاصلاح يهاجمنا صقور الحزب الحاكم و من هم في النظام على أننا نسعى الى هزّ أركان الدولة. السيد الرئيس ذكر في كل مقابلاته على أهمية الاصلاح و اننا تأخرنا كثيراً و خاصة على الصعيد السياسي، فهل هؤلاء المعترضون يعملون ضد مصلحة سوريا و رئيسها؟
في النهاية، أعتقد أن أفضل شكل حكم لسوريا هو النظام السياسي المختلط، و توزيع الصلاحيات التنفيذية بين رئيس الجمهورية و مجلس الشعب، مع ابقاء القضايا الأمنية و الاستراتيجية بيد رئيس الجمهورية الذي بدوره يمكن أن ينشئ مجلس وطني أعلى يضم وزير الخارجية و الدفاع و الداخلية و رئيس الوزراء، لاتخاذ القرارات الحاسمة في أوقات الأزمات و الحروب.
[1] Abdul Majid Soualem, Fighting Sectarianism with Sectarianism, http://www.al-ayyam.com/article.aspx?did=48410&date=2/1/2007
ما رأيك بهذه الدراسة ؟ و هل قدمت حلا عمليا للقضية المطروحة ؟ وما مدى قابليتها للتطبيق في المدى القريب ؟