News and Opinion:
و تعطّلت لغة الكلام
Tuesday, January 22nd, 2013
و تعطّلت لغة الكلام …
مازن صالحي
لقد وصل الاستقطاب بين السوريين إلى مستويات غير مسبوقة من التوتر و الحدّة، بحيث بات يهدد – و بدون أي مبالغة – كيان الوطن السوري في الصميم على المدى القريب و المتوسط، و ربما حتى البعيد. و فيما توجد الكثير من التحليلات التي تتناول الأزمة من مناظير مختلفة، نريد في هذه السلسلة من المقالات أن نعالج مواضيع متعلقة بجذور التواصل و الوعي و تكوين الرأي لدى الفرد و المجموع السوري، لأنه في الجذر من كل هذا الاستقطاب عوامل نفسية و اجتماعية يمكن تشخيصها و تحليلها بشكل علمي، و أصل الدواء معرفة الداء.
من منا لم يدخل في نقاشات حادة مع أقرب الأصدقاء، ليخرج منها دون أي فائدة، بل و ليحمل بعدها المزيد من المرارة و الغضب، و دون أن يتمكن من زحزحة الطرف الآخر عن مكانه قيد أنملة؟ من منّا لم يتساءل، أن كيف يمكن للطرف الآخر أن يكون بهذا “الغباء” و هذه “الضحالة” و تلك “السذاجة” و ذاك “العمى” و كيف يمكن لهذا الطرف الآخر أن يدعم قوى الشر الخالص التي يدعمها؟ و من منّا لم يضرب كفاً بكف حسرة على جيرة أو صداقة أو قرابة دامت عشرات السنوات، ليكتشف بعدها ما كان مخبوءاً بداخل هؤلاء الأصدقاء من “شر خالص” و “طائفية بغيضة” و “حقد أعمى” و غير ذلك من النعوت، نضعها كلها هنا ضمن علامات تنصيص لأننا لا نوافق عليها و لا نأخذ بها، و لكن نوردها كما ترد على الألسنة. طبعاً، و لا بد أن نذكر ذلك لأن هناك من قد يتناساه، فإن هذه الملاحظة تنطبق على الطرفين: طرف المؤيدين للنظام، و طرف المعارضين، المنحبكجية و العراعير، الأسديين و الأحرار، السوريين … و السوريين أيضاً.
كيف يمكن أن تنفجر فجأة كل هذه الاختلافات و بكل هذه الحدّة؟ أين كان كل هذا الخلاف الهائل مخبوءاً؟ و لماذا نفشل في الحوار مرة بعد مرة بعد مرة؟ مع اعترافنا بالتدخل الخارجي الهائل في الأزمة السورية، إلا أنه لا بد لنا من الاعتراف أيضاً بأن هذا التدخل قد عرف كيف يحكم توجيه ضرباته إلى نقاط الضعف البنيوية الكثيرة التي يشكو منها المجتمع العربي عامّة، و السوري خاصّة، و علينا إن نحن أردنا معالجة المشكلة أن نتجه إلى جذور الآفة لا إلى أعراضها، و علينا أن نبحث في أسباب هذا الفشل في التواصل لأنه أساس المشاكل.
تخبرنا علوم الأنثروبولوجيا أن ضخامة حجم الدماغ لدى الإنسان تطورت بهذا الشكل المميز لتمكينه من القيام بأصعب مهمة على الإطلاق. هذه المهمة الصعبة و المعقدة الموكلة بهذا العضو، لا تزال هي نفسها بعد ملايين السنين من التطور. هذه المهمة الخطيرة هي أن يفهم بعضنا بعضاً. هذا التواصل (Communication) هو عملية جد معقدة و تستهلك إمكانيات مهمة من عضو التفكير لدى الإنسان، و الذي بدوره يستهلك ربع الطاقة التي يستهلكها الجسم بشكل عام. و كأي عملية معقدة، فإنها تعتمد على سلسلة من العمليات المتشابكة التي يجب أن تعمل بتناغم لتنجح، و أيضاً كأي عملية معقدة، فإنها يمكن أن تتعرض للتخريب أو العبث بسهولة نسبية بما يحرفها و يسبب فشلها.
ما أريد قوله هنا بشكل مبسط هو أن عملية التواصل و التفاهم بين الأفراد ليست عملية بسيطة. ليست عملية ميكانيكية خشنة و عصية على الخلل. ليست، ربما، مثل التنفس أو بلع الطعام. بل هي عملية مرهفة الدقة و عالية الحساسية، و هذا بالضبط، ما يجعل أفراد الجماعات البشرية قادرين على التعاون الخلاق و المبدع و الذي ينتج لنا الإبداعات الجمعية للإنسان، حيث يعمل المئات و الآلاف و عشرات الآلاف معاً لبناء إنجازات الحضارة. و لا يوجد أي إمكانية للحضارة، أبداً، بدون هذا التفاهم و التواصل بين الأفراد. و كلما عظمت المنجزات الجمعية لحضارةٍ ما، كلما ارتقت و ارتفعت تلك الحضارة، و كلما ظلت ثقافتها فردانية و غير جمعية، كلما ابتعدت عن التاريخ نحو الهامش و نحو الانفراط.
و لكن، و على الرغم من آلاف السنين من العمل على تطوير اللغات البشرية، و تطوير أساليب استخدامها، فلم تنجح كل الشعوب و لا كل المجتمعات في إتقان آليات التواصل و التعاون بين أفرادها، يمكننا تلمس فروق واضحة في سلوكيات بعض الشعوب عن بعضها الآخر في هذا الخصوص، بحيث نرى بعض الثقافات قد أتقنت آليات التواصل بين الأفراد و آليات صناعة المعرفة و القرار، و بين شعوب أخرى لم تتقن هذه الآليات و لا تزال تحبو حبواً على تلك الأصعدة. و لعل من أكثر الأمثلة سطوعاً كانت الفتوحات الأوروبية الاستعمارية للعالم، حيث كانت قوى منظمة من بضعة آلاف من الأوروبيين تتمكن من إخضاع مجموعات سكانية بالملايين، و من إدارتها و التحكم بها بنجاح. أتقن الأوروبيون تلك التقنيات التواصلية فيما بينهم، و لم تتقنها الشعوب المستعمرة التي كانت (و لا يزال الكثير منها) يعاني من ضعف مزمن على صعيد التواصل الفعال بين الأفراد.
لماذا أفتح هذا الموضوع؟ لأنني مقتنع بأن له علاقة وثيقة جوهرية كأحد أسباب الاستقطاب الحاد بين “أفراد” المجتمع السوري، و بفشلهم في التواصل و التفاهم و الحوار، و أريد أن نستعرض بعض الآفات المستحكمة فينا اجتماعياً و التي تساهم في تكريس عجزنا عن التواصل، و بالتالي عن التفكير أو الإنجاز الجمعي.
فلنبدأ من اللغة ذاتها. اللغة التي نستعملها. لنضعها تحت الضوء، و لننظر إلى بعض الأمثلة التي نستخدم فيها اللغة أمام جمهور كبير، مثل الخطب الدينية (1)، أو الشعر النبطي (2)، أو شعر المديح القومي (3)، أو الزجل (4) الشعبي، أو روائع مهرجان الجنادرية (5) “الثقافي”، أو مداخلات أعضاء مجلس الشعب السوري السابق المبتذلة (6). أدعو القارئ الكريم إلى متابعة الوصلات ليرى معى تجليات واضحة للآفات اللغوية التي أحاول تسليط الضوء عليها. في كل الأمثلة التي أوردتها هنا، و في الكثير الكثير غيرها، نجد تلك اللغة المتصنّعة المنمّقة المتكلفة التي لا نزال نعتمدها في الكثير من منصّاتنا العامة. نجد لغة السجع و المحسّنات البديعية، لغة التوابل و البهارات التي تزين محتويات غذائية فارغة مثلما تفعل التوابل الكاذبة في مطاعم الوجبات السريعة، فتخدع حواسنا و توهمنا بأن ما نلتهمه طعامٌ صالح للاستهلاك الآدمي، بينما هو في الحقيقة مواد مسرطنة. نجد لغةّ، تهتم بأصوات الكلمات على حساب معانيها، و بتنميقها و زخرفتها، على حساب محتواها.
من الصعب، حقّاً، وصف مدى الضرر الذي ألحقته هذه الآفة بفعالية التواصل بيننا، أفراداً و جماعات. بل إنني أزعم أن إدراك ضررها قد يكون مستحيلاً على من لا يتحرّاه في المتداول من اللغة، على أن يتقن لغة أخرى إتقاناً عالياً، بحيث يمكن أن يشعر بشكل مباشر بمدى تخلف اللغة العربية المتداولة و مدى قصورها عن التعبير.
فإذا سلطنا الضوء على الكثير من اللغة المستخدمة في الجزء الأكبر من محافلنا العامة، فإننا نجد بشكل واضح، جوائح النثر السجعي، و الطباق، و إرداف كل الجمل بكلمات إضافية مشابهة، و نجد التكرار، و الحشو، و الافتعال و المبالغة المخلّة، و التصاوير التهويلية، و المنفخة، و استخدام الألفاظ في غير معانيها، و التورية و عدم المباشرة، و علل أخرى كثيرة كلها تساهم في الإغمام و التعمية على المعنى و المحتوى، على حساب الزُخرُف. و هذه الآفة منتشرة إلى درجة يكاد ينعدم معها الإحساس بالفرق بين الحقيقي و المجاز.
و المصيبة أننا نعتبر هذه الآفات جمالاً و فنّا. و بينما تصنع الشعوب الأخرى فنونها بأدوات الموسيقى و الرسم و التصوير و النحت، و تُحافظ على حذرها من ابتذال لغتها و شرشحتها بهذا الشكل، لأنها أداة التواصل و بناء الحضارة الأساسية، تصر ثقافتنا العربية على تعاطي الزخرف الكاذب، و على إدمانه، و لتذهب كل المعاني إلى الجحيم، و لتبتذل اللغة و لتمتهن ما دامت الزخرفة الصوتية تسحر السامعين.
أدعو القارئ الكريم إلى التوقف قليلاً و التفكر في التراكيب التي يقرأ أو يكتب أو يسمع، مع الانتباه إلى الآفات المذكورة، و سيجدها منتشرة انتشار الوباء. انظُر بشكلٍ خاص في الخطاب الديني، و في الخطاب السياسي المطعّم بالدين، و في أي خطاب تخاطبُ فيه سُلطةٌ ما (دينية أو سياسية أو إعلامية) الجماهير، حيث تصبح خواص التعمية و التورية و الغش مطلوبةً بشغف، فستجد أن كل تلك الآفات توظّف بإصرار غريب. جرب أن تقتطع خبراً من جريدة رسمية عربية، تتحدث بهيام عن الملك أو الرئيس أو الأمير، و جرب أن تترجمه حرفياً إلى لغة أوروبية (انكليزية أو ألمانية بشكل أساسي)، و انظر علام تحصل. ستحصل على نص يدعو للرثاء، مزخرف بشكل ممجوج في كل العالم المتحضر، و هزيل المعنى. تفكّر قليلاً، عزيزي القاريء، في التراكيب التي يسبكها شعراءنا، في المرة القادمة التي تستمع فيها إلى الشعر، و تأمل كم فيها من المبالغة و التورية (أي اللف و الدوران) و التهويل و الكذب. و نحن أمةٌ شاعرة، كما نفخر، و نقول بلا حياء: أعذب الشّعرِ أكذبُه. انتبه كيف تعجبنا التصاوير المعقدة التي تحتاج إلى الكثير من الخيال لفك طلاسمها و فهم ما يريد الشاعر قوله، و كيف تتولد لدينا اللذة من فهم ما يريد الشاعر قوله بعد فك الطلاسم و حل العقد المسبوكة، و كأن فك الطلاسم هو الغاية، و كأن حل العقد هو الهدف، و كأن اللغة أداة تسليةٍ و ترف، لا أداة تواصل.
ما النتيجة من هذه “الثقافة” كلّها؟ النتيجة أننا نخرب الأداة الأساسية اللازمة للتواصل فيما بيننا، و نخرب بالتالي فرصنا في الحوار و التواصل، و في صناعة الحضارة. إننا باعتماد هذه الثقافة اللغوية البائسة، نخرّب عملية التواصل تخريباً. ننسى أن الأصوات ليست سوى رموز للمعاني و نهيم افتتاناً بالأصوات و برقصاتها، فتتحول الرموز إلى غاية بذاتها، لننسف عملية التواصل من أساسها. تبهت الكلمات و لا يعود لها معنى، مثلما تفسد حاسة التذوق بإكثار التوابل اللاذعة في الطعام. و يغدو تواصلنا قاصراً، منحصراً في الأفكار البسيطة، و غير قادرٍ (بشكل جمعي) على تداول الأفكار العليا التي تحتاج إلى درجة عالية من التجريد. تتراجع إلى حدود الصفر، قدرتنا على النقاش، الذي يقتضي أولاً الاتفاق على المعاني. نضخّم الحدث الصغير باللغة الفخمة و نعطيه حجماً لا يستحقه، و نعرف أننا نفعل ذلك. و عندما يأتي دورنا للاستماع نعيد دوزان حواسّنا على أساس أن اللغة التي نستقبلها كلها مبالغات أصلاً، فنخفف من حساسيتنا للكلمات التي تردنا، فتنهار الأفكار قبل أن تصل إلينا عبر الكلمات. يرى المتحدث أنّه لا يصل إلى من يُحدّث، فيلجأ إلى التصعيد اللغوي الشديد، فيزيد في عيار المبالغات و التهويل، و لكن كل ما يفعله هو أنه يدفع بالطرف المستقبِل إلى صمّ أذنيه بشكل أشدّ. و و هكذا يضيع الحوار.
لقد تعوّدنا أننا أمّة تقول ما لا تعني، و تعني ما لا تقول، و لذلك فنحن لا نثق بأقوالنا و لا بآرائنا و لا بأخبارنا، فهل نتفاجأ عندما نعجز عن الحوار عند أول مشكلة؟ حدثني أحد الأصدقاء الغربيين عن حادثة جرت مع ابنته التي يعمل معها في الشركة شاب مسلم من أصول عربية. قال ذلك الشاب أنه مستعد لقتل كل من يهين الإسلام أمامه، مما أخاف الفتاة، و أثار الغضب الشديد لدى الأب لدرجة أنه فكر بالاتصال بالشرطة. في العالم الغربي عندما يقول أحدهم (في غير مجال المزاح) كلمةً كهذه فإنها تؤخذ حرفياً، فهم قومٌ ينتقون كلامهم و يعنون ما يقولون أكثر منا بكثير. قلتُ له أن هذا الشاب لا يعني ما يقول حرفياً، فهدأ روعه. و لكن هي الحقيقة، فقيمة الكلمات عندنا تختلف عن قيمتها عند الغربيين، و لربما يمكننا تشبيهها بفرق العملة، كلمة واحدة من هناك تساوي مئة كلمة مما يعدون.
في نظري، فإن ابتذال اللغة بهذا الشكل، و هو آفة ثقافية بحتة، لا علاقة مباشرة لها لا بنظام و لا بمعارضة، هو أحد أهم أسباب فشل الحوار فيما بيننا كسوريين نحاول أن نتحاور تحت النار و تحت الضغط الشديد و باستخدام أداة لم نهيئها لتخدمنا في الأوقات العصيبة. نحن كمن يحاول إصلاح سيارته بمفكات براغي مطعمة بالصدف و الياقوت، و محفورة بالزخارف الفارهة، إلى درجة أنها صارت خاويةً هشّة. ما أن نمسكها و نبدأ بمعالجة العطل الذي طرأ على المحرك، حتى تتهشم بين أصابعنا و تتحول إلى غبار. غبار كلمات و ليست كلمات. و لكن نحن بحاجة إلى إصلاح المحرك و الانطلاق بسرعة قبل أن يلتهمنا الطوفان القادم بقوة، إلا أن كل أدواتنا فاشلة، صنعناها للزينة و ليس للعمل.
إن إصلاح هذا الخلل سيحتاجُ جيلاً كاملاً على الأقل، و ربما أجيال عديدة، و لكن ربما يمكننا أن نخفف من تأثيره في أن نحاول، عند كل حوار، عند كل استخدام للكلمة، أن نركز على المعنى، و أن نتفق على المصطلح، و أن نحافظ على هدوء المفردات، و ألا نبالغ و لا نهوّل، مهما كنّا متحمسين لفكرتنا. إنه لمن العار أنه يكون مستوى تواصلنا يشبه مستوى تواصل إنسان ما قبل اللغة، ذلك الذي لم تكن لديه مفردات كافية يعبر بواسطتها عن أفكاره، و لم يكن لديه غير البلطة أداةً للحوار. افهموا يا أحفاد مبتكري الأبجدية.
1- http://www.youtube.com/watch?v=TiA57zOAXb8&feature=youtu.be&t=15s
2- http://www.youtube.com/watch?v=AsK7FVCw6uY&feature=youtu.be&t=44s
3- http://www.youtube.com/watch?v=MI7OBNNah1E&feature=youtu.be&t=29s
4- http://www.youtube.com/watch?v=SZ0BzHEI2Ww&feature=youtu.be&t=40s
5- http://www.youtube.com/watch?v=j7A7dIjIAkc&feature=youtu.be&t=22s
6- http://www.youtube.com/watch?v=8sqhoV8IxX0&feature=youtu.be&t=38s
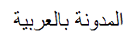





 CreativeSyria
CreativeSyria
Comments (3)
همام نشار said:
شكراً لهذا الكلام الرائع. سأبقي حقي في التمعن فيه ملياً لكني أحببت أن أكون الأول الذي يضع تعليقاً بالقرب من اسم الكاتب
March 1st, 2013, 11:47 pm
Mazen Salhi said:
Thank you, Humam,
(sorry, typing from an English Keyboard)
Sorry for the delay in getting back to you, and thank you for your comments.
June 5th, 2013, 3:27 pm
همام نشار said:
Very happy to read your comments. Would like to get in touch with you at your free time and earliest. I missed the the opportunity to thank you for your excellent translation on Camile article
June 13th, 2013, 12:58 am
Post a comment