لقد بني النظام الإقتصادي السوري طوال اربع عقود على فكرة ملكية الحكومة على قطاعات كاملة من الإقتصاد مع الإبقاء على القطاعات الأخرى تحت الرقابة المباشرة للحكومة أو للمنظمات الوسيطة التي تسيطر عليها الحكومة. واستطاعت هذه المنظومة أن تقود مرحلة هامة من النمو الإقتصادي المتسارع في فترة السبعينيات معتمدة على ريعية العائدات النفطية ومساعدات دول الخليج في أعقاب حرب 1973 مع اسرائيل. ورغم أن القيود على التضخم الذي يرافق عادة النمو المتسارع بقيت تحت سيطرة الحكومة التي قامت بتوفير شبكة ضمان اجتماعي أساسي في قطاعات الصحة والتعليم والخدمات الإجتماعية والتوظيف الحكومي إلا أن استحقاقات العجز العام والمديونية انفجرت في النصف الثاني من الثمانينيات. ولم تعد الدولة قادرة على الوفاء بالتزاماتها الأساسية من ناحية توفير شبكة الرعاية والحماية والحد الأدنى من الرفاه الإجتماعي. ولكن التوجه الذي استمر لأعوام طويلة وكرس نظرة لدى المجتمع السوري حول دور الحكومة الإقتصادي بقي يحكم السياسات العامة وتوقعات المجتمع على حد سواء، حتى بعد أن تبين فشل تلك السياسات وعدم قدرتها على متابعة استحقاقات التنمية. فهناك نظرة عامة لدى السوريين أنهم يستحقون كل خدمات الدولة المجانية وأنهم لن يدفعوا إلا الحد الأدنى من الضرائب وأن رواتبهم يجب أن تزداد وأن يتم كل ذلك بأقل قدر من التضخم.
لقد جاءت الإصلاحات الإقتصادية كضرورة ملحة لمحاولة إدخال القطاع الخاص والإستثمارات المحلية والخارجية في تمويل النمو الإقتصادي وفتح أفاق جديدة للإقتصاد السوري قادرة على استيعاب النمو السكاني المتزايد ودخول مئات الألاف من الشباب إلى سوق العمل كل عام. وإذا كانت الإصلاحات الإقتصادية قد نجحت في تحرير قطاعات اقتصادية واسعة وجلب استثمارات خارجية إلا أنها بقيت رهينة منظومة عامة سياسية وأخلاقية ترى أن دور الحكومة هو الأساس وأن دور القطاع الخاص يبقى ثانوياً مهما كبر. فلم ترافق حركة النمو الإقتصادي حركة موازية من الإصلاحات القضائية والإدارية والسياسية. وكانت النتيجة أن نسب النمو المستمر التي عاشتها سورية خلال السنوات الست الأخيرة قبل بداية الأزمة لم تنعكس على شكل فرص اقتصادية حقيقية بالنسبة للسواد الأعظم من السوريين.
فرغم نمو كل المؤشرات الأساسية الخاصة بالإقتصاد الكلي إلا أن المؤشرات التفصيلية بقيت شبه جامدة. فنمو الناتج المحلي جاء في قطاعات ذات انتاجية عالية ولكنها لا توفر فرص عمالة كبيرة. فنمت فرص العمل في الوظائف الخدمية على حساب الوظائف الإنتاجية. وجاء النمو الكبير في قطاعات الأعمال والمصارف مثلاً مترافقاً مع ضياع فرص عمالة كبيرة في قطاع الزراعة. وكذلك ترافق نمو طبقة متوسطة واسعة الطيف (مليون سيارة صغيرة 1600 ccخلال العشر سنوات الماضية) على حساب ترسخ الفقر لدى شريحة المواطنين تحت خط الفقر المدقع. كل هذا خلق شعوراً عاماً بأن الهوة بين الفقراء والأغنياء صارت كبيرة إلى درجة لم تتقبلها الثقافة السورية المرتبطة عضوياً بالتجربة الإشتراكية السابقة.
وجاء الإصلاح الإقتصادي مجزءاً لم ترافقه إصلاحات سياسية وإدارية تسمح بالمحاسبة والمساءلة بما شجع على استفشاء أنواع من الفساد فاقت كل ما عرفته سورية في السابق. وبقي النمو الإقتصادي محصوراً بيد شبكات من المحسوبيات لم تسمح من الإستفادة من عائدات النمو الإقتصادي وتوزيعها بشكل عادل لتصيب الفئات الأفقر من المجتمع. كما عجزت السياسات التي وضعتها الحكومة في خلق شبكة حماية مجتمعية للتعامل مع النتائج المتوقعة من عملية التحرير الإقتصادي. وبقيت الحكومة تعتمد أدوات غير مجدية وغير كافية للدعم الأساسي للفقراء بدون أن تطور هذه الأدوات وتربطها بأدوات تمكين مجتمعية تساعد الفقراء في الخروج من دائرة الفقر واستمر تكريس فكرة الإتكال على الحكومة في كل شيء رغم تغيير دور الحكومة جذرياً.
ورافق هذا الشعور العام بالغبن الإقتصادي جمود في أدوات التنمية البشرية مقارنة بدول أخرى في الجوار. فرغم أن سورية كانت سباقة في تقديم عدد من الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم إلا أن الشعور العام هو أن الحكومة لم تطور أدواتها بشكل كاف وأن دول الجوار قد سبقتنا. وتعزز هذا الشعور عندما وقعت سورية اتفاقات اقتصادية مع دول مثل تركيا اتضح من خلالها ضعف القدرة التنافسية للإقتصاد السوري ولمؤشرات التنمية البشرية مقارنة بجوارها. وهذا أيضاً عزز شعوراً عاماً بأن الحكومة لم تحمي الإقتصاد المحلي كما يجب.
خلاصة فإن السياسات العامة للتحرير الإقتصادي بقيت موضع جدل كبير بين المستفيدين منها والمتضررين. وجاءت الأزمة لتزيد من حدة التخبط حول السياسات الإقتصادية. فمن طرف هناك من يطالب بمزيد من التحرر والإنفتاح ومن طرف أخر هناك من لحق التوجهات الشعبوية وألقى بكل اللوم في الأزمة على سياسات الإنفتاح الإقتصادي. إن النقاش الإقتصادي الموضوعي لا يغيير من النظرة العامة لدى الكثيرين على أن الإنفتاح الإقتصادي جاء بنتائج متواضعة وغير كافية، متأخرة، وموزعة بطريقة غير عادلة. وزاد من حدة هذا الجدل أن الحكومة حاولت أن تلبس الأشخاص المسؤولين عن الإنفتاح الإقتصادي في سورية مسؤولية الأزمة بينما تبقى الحقيقة المرة هي أن مسببات الأزمة هي إقتصادية بالدرجة الثانية ولكنها مرتبطة بالإصلاح الإداري ومشاكل الفساد وانعدام المساءلة بالدرجة الأولى.
إن الدور الإقتصادي للحكومة في المستقبل سيؤثر في شكل الحل الذي ترتجيه سورية للخلاص من الأزمة. هل ستقترض سورية لتغطية نفقات إعادة الإعمار، ومن الذي سيقرضها وضمن أي شروط؟ وكيف ستستطيع سورية أن تسدد القروض التي ستقترضها لإعادة البناء؟ هل ستعتمد الدولة سياسات دعم العرض كما في السابق وتدافع عن دور المؤسسات العامة وتدعم الإنتاج عبر مؤسسات القطاع العام. أم أنها ستدعم دور القطاع الخاص وتخلق سياسات تحفز الطلب. هل ستنفذ عمليات إعادة الإعمار عن طريق عطاءات عامة قد تكون سريعة ولكنها غير فعالة وغير مولدة للعمالة أم أنها ستأتي عن طريق حوافز مجتمعية قد تكون بطيئة ولكنها قليلة الكلفة ومولدة للعمالة ضمن الفعاليات الصغيرة والمتوسطة؟
كل هذه الأسئلة ستحدد للسوريين ملامح الإقتصاد الذي سيعملون من خلاله وسترغمهم على اتخاذ اختيارات صعبة فيما يخص مستقبلهم. لذا يطالب الكثير من السوريين اليوم أطراف النزاع أن يحددوا بوضوح إلى أي نهج اقتصادي سيأخذون البلد مستقبلاً. وحيث أن كل شيء في الأزمة السورية أخذ نزعة حدية فإن الحوار الإقتصادي صار أيضاً مجالاً للخلاف بين المصالح المتنوعة والمتعارضة. ويسعى الكثيرون اليوم إلى الضغط لتحديد شكل الإقتصاد السوري مجدداً ضمن أطر تحمي مصالحهم. ولكي يضمنوا هذه المصالح يطالبون بتحديد شكل الإقتصاد السوري في الدستور.
في الحقيقة لا يوجد تصور واضح ودقيق لمعرفة أراء الأكثرية في هذا الصدد. وحتى لو كان هناك مثل هذا التصور فإنه عرضة للتغيير بحسب المستجدات. وتبقى كل الإسقاطات التي يقوم بها البعض لتصوير رؤيتهم على أنها النموذج الأنسب من باب التفكير الطوباوي. إن توصيف النظام الاقتصادي الأنسب للسوريين هو من الأمور الأساسية التي ستتنافس عليها الأحزاب السياسية مستقبلاً. وهذا التوصيف سيتغيير باستمرار بحسب تغيير رؤية الناخبين. المشكلة تكمن في عدم وجود نظام سياسي يسمح بتغيير السياسات الإقتصادية عندما تثبت فشلها (أو انقضاء فترة صلاحيتها). سيكون على الناخب السوري مستقبلاً أن يقرر ما هي المعادلة الصحيحة وهذا لا يكون إلا عبر عدة دورات انتخابية حرة وشفافة تتبلور فيها تجربة الرقابة على الاقتصاد عن طريق العملية الديمقراطية. والقرار حول مستقبل سورية الإقتصادي يجب أن يكون للناخب السوري وليس للنخب السورية، بطريقة تضمن فيها المؤسسات الديمقراطية تصحيح المسار كلما فشل السياسيون في وضع حلول اقتصادية حقيقية لمشاكل البلد.
قد يكون من السابق لأوانه اليوم الإنخراط في الحوارات النظرية حول الشكل الإقتصادي للمرحلة القادمة في ضوء الأسئلة الأكثر إلحاحاً في تأمين الإحتياجات الإنسانية الأساسية. خاصة وأن هذه الأسئلة تطرح اليوم من قبل الكثيرين من باب إلقاء اللوم وليس من باب إيجاد الحلول. إن الأسئلة الإقتصادية الأهم في هذه المرحلة ستتمحور حول أولويات المساعدات الإنسانية والإغاثة. وحول شكل الحوافز المتوفرة لإعادة الإعمار واستقرار وعودة النازحين. وستدور حول التعويضات للمتضررين وعلاج الجرحى وغيرها من الضروريات الأساسية. كما يجب البحث عن حوافز مجدية لجمع السلاح من أيدي كل الأطراف المسلحة وإغرائها بالخروج من اقتصاد الحرب الطفيلي إلى إقتصاد السلم الإنتاجي. أما الأسئلة الصعبة حول طبيعة النظام الإقتصادي وبالتالي طبيعة النظام الضريبي وما يتبعه من القوانين المرتبطة بالعمل والحماية التي يوفرها القانون للعمال والتوازن بين هذه الحقوق والحوافز التي ستوضع لاستقطاب الإستثمارات إلى سورية مجدداً فهذه أسئلة لا يمكن الإجابة عليها بدون نظام ديمقراطي سياسي يحدد طبيعة الإقتصاد السياسي للبلاد من خلال المؤسسات الديمقراطية وليس عن طريق السماح للرابح في الأزمة من فرض رأيه بقوة السلاح .

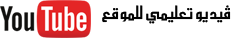


أترك هذا النقاش للسوريين اللذين اختصوا في هذه المجالات لأن الأزمة لها حلولها الإقتصادية الخاصة . إنما بالمطلق لا يهم المواطن سوى العدالة الإجتماعية و تنظيم فرص العمل و العمل على خلق هذه الفرص و راتب بطاله يقتص من الدخل القومي مباشرة و لو على حساب الجميع فحق الإنسان العاطل عن العمل على الإنسان العامل أن لا يموت الديب ولا يفنى الغنم.
Syria needs free market with protection to local industry and tax break on all export with no tax on these profits with a safety net for the poor and the unemployed, the tax system need to be changed, and with bribery it might be better to have a sale tax that is easier to collect than an income tax the tax can be none for clothes and food, the problem that i faced in Syria is that everything was granted and there was no way to get out of certain level of income , education is free health care is free, but there is no way for people to start a business and get rich, so low interest lawns and regulations that makes it easier to start a business and ability to go bankrupt if you do not make it will encourage the Syrians to take a chance Taxation can be a way to close the income gap that will satisfy the poor and decrease their anger..
في حال الاستقرار لبلدنا لعزيز ولتخلص من لجراثيم يلي فاتتلو بهلسنتين واعادة قوة دولتنا ومكانتها يلي كانت عليه ابل الازمة
لازم نعمل على تعميق حرية الاقتصاد وفتح لمجال اكتر أمام المستثمرين السوريين بالاخص باستثمارات كبيرة مهيمن عليها بعض الاشخاص بلبلد مما دفع بعض لتجار الاصليين لهجرة البلد للبحث على رزئن برا البلد
من ناحية آخرى لازم ينعطى حرية كبيرة لفتح مشاريع اقتصادية متوسطة يلي بتعاني من قيود كبيرة في قانونا الاقتصادي الموجود قانونا او القوانين يلي خترعوها بعض عناصر الامن والادارة المحلية او حتى موظفي الاقتصاد بالاخص الصغار لاتخاذها مصدر رزقن كاختلاق ذرائع لاصحاب المحلات حتى يرشوهم مع العلم انو المشاريع المتوسطة هيه الحل الناجع يلي البلد بحاجة الو نتيجة طبيعة البلد المحتاجة لبعض المنتجات غير الدائمة والحل يلي بتحملو من تشغيل جزء واسع من شعبنا فيها للقضاء عالبطالة
بلنتيجة بظن انو الحل يجب ان يقوم بمحاربة الفساد للنهوض بدولة اقتصادية بامتياز